
حققت العلوم الطبيعية تقدّمًا هائلاً بمعدّل سريع وثابت، حتى صارت النموذج المثالي للمعرفة. بينما تعاني العلوم الإنسانية من تعثّرات منهجية واضطرابات علمية، رغم تقدّمها الكبير خلال القرن العشرين. لم تنجح العلوم الإنسانية بعدُ في تقديم ذلك النسق المتكامل من النظريات والمناهج التي تقدّم تفسيرات للظواهر الاجتماعية والتفاعلات الإنسانية كما فعلت نظيرتها العلوم الطبيعية. أين تكمن مشكلة العلوم الإنسانية تحديدًا إذن؟ بل ما هي ملامح هذه المشكلة ومكوناتها؟
نظرة إجمالية على مشكلة العلوم الإنسانية
مؤلفة الكتاب هي الأستاذة الدكتورة يمنى طريف الخولي، من مواليد عام 1955، تعمل أستاذة للفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، وتنصبّ غالب أبحاثها ومؤلفاتها على فلسفة العلوم ومناهج البحث، ويصل مجموع كتبها وترجماتها إلى قرابة 25 كتابًا، غير الأوراق البحثية المحكّمة باللغتين العربية والإنجليزية، وحصلت على 14 جائزة علمية.
في هذا الكتاب تتناول المؤلفة مشكلات العلوم الإنسانية، وقد اهتمت بتناول تأثير العلوم الطبيعية وتطوراتها على العلوم الإنسانية، ودائمًا ما تعقد مقارنات لتوضيح أفكارها، فعرضت لنظرية المعرفة الكلاسيكية ونظرية المعرفة المعاصرة، وأهم الفلاسفة والعلماء الذين أثروا في فلسفة العلم ونظرية المعرفة، مثل جاستون باشلار وتوماس كون وكارل بوبر وغيرهم.

تبدأ المؤلفة كتابها بـ”مقدمة في المصطلح”، وتبين أن كلمة scientist في اللغة الإنجليزية تستخدم لوصف من ينشغل بالمعرفة حول الطبيعة والكيمياء، ومناهجها الصارمة، وفي المقابل تُرجمت كلمة science إلى العربية بمفردة “العلم”، وتُرجمت scientist إلى مفردة العالم، وكلا من مصطلحي العلم والعلماء لهما دلالات واسعة للغاية في الاصطلاح العربي.
بالتالي لدينا مصطلح العلم وهو مصطلح شديد العمومية، في مقابل كلمة scientist وهي كلمة لها دلالة محددة ودقيقة. وهو ما ستستخدمه المؤلفة في كتابها لتعبر عن “أنساق تفيد مضمونًا إخباريا، ومحتوى معرفيًا، وتوصيفات دقيقة، وقوة شارحة، وقدرة تفسيرية، وطاقة تنبؤية، مُنصبّة على ظواهر العالم التجريبي والواقعي الواحد والوحيد الذي نحيا فيه”، وعلى هذا فمصطلح العلوم الإنسانية يشير إلى البحث المنهجي حول الذي يقدم وصفًا وتفسيرًا للظواهر الإنسانية كعلوم الاجتماع، والاقتصاد، والنفس، والأنثروبولوجيا.
علوم اجتماعية أم علوم إنسانية؟
تتناول المؤلفة مسألة مهمة وهي: هل المصطلح الأنسب للتعبير عن العلوم التي تدرس الظواهر البشرية، أن تُسمى علومًا إنسانية أم علومًا اجتماعية؟ هناك اختلاف في الأوساط الأكاديمية الغربية التي هي منشأ هذه العلوم في العصر الحديث. ترجح المؤلفة أنّ الأفضل هو استخدام مصطلح العلوم الإنسانية، لأن الإنسان في الأخير هو الموضوع المحوري التي تدور حوله هذه الدراسات والأبحاث.
تطور العلوم الطبيعية
في الفصل الأول، أوضحت المؤلفة أن العلوم الطبيعية قد بلغت ذروة تقدمها في القرن العشرين، حتى قيل إن 75% من علم الفيزياء الموجود بين أيدينا قد أُنتج في القرن العشرين، وأن كلا من الكوانتم والنسبية أصبحتا الأساس لعلم الفيزياء، ومن ثمّ لنسق العلوم الطبيعية في القرن العشرين، بما أنتجتهما من إبستمولوجيا ومنظومات معرفية جديدة.
تخلف العلوم الإنسانية
كذلك لا يمكن إنكار التقدم الهائل التي حققته العلوم الإنسانية في القرن العشرين؛ لكنها بالمقابل لم تنجح في تقديم نسق متكامل من المناهج والنظريات التي تقدم تفسيرات وتضع قوانين للتفاعلات الإنسانية والظواهر الاجتماعية كما فعلت العلوم الطبيعية، ولعل من أسباب ذلك غياب الاتفاق حول تصور واضح حول أهدافها ومناهجها المشتركة والعلاقات بينها، كما أن الرأي العام السائد في العالم يعطي مكانة أكبر للعلوم الطبيعية التي تتقدم بسرعة وثبات حتى صارت النموذج المثالي للمعرفة على عكس العلوم الاجتماعية التي يعاني تقدمها من اضطرابات علمية ومنهجية.
وبناءً على ذلك، ترى المؤلفة أن أبرز العقبات التي لابد للعلوم الإنسانية أن تتجاوزها، هي السعي للحصول على تفسيرات أعلى وأكثر كفاءة للظواهر البشرية والتفاعلات الاجتماعية. بعبارة أخرى فالعلوم الإنسانية أجادت القيام بوظيفة “التوصيف”، إلا أنه رغم كل شيء تبقى وظيفة “التفسير” هي المعيار الحقيقي لتحديد مدى تقدم تلك العلوم.
مشكلة العلوم الإنسانية
هناك عدة خصائص تتمايز بها العلوم الإنسانية عن نظيرتها الطبيعية، على رأسها صعوبة التكميم (أي: صعوبة تحويل المؤشرات إلى أرقام)، واستخدام الألفاظ الكيفية، وبالتالي عدم إمكانية صياغة قواعد وقوانين دقيقة يمكن تعميمها، كما أن الباحث نفسه الذي يقوم بفحص ودراسة الظواهر البشرية والتفاعلات الاجتماعية له ميوله وأهواؤه الخاصة التي تؤثر ولا ريب على نتائج دراسته، فقضايا العلوم الإنسانية ليست كالتفاعلات الكيميائية. كما أن هناك مشكلة أخرى تواجه العلوم الإنسانية مثل ضعف التمويل المصروف لها؛ نتيجة للتشكيك في نتائجها وجدواها، وفي بعض الدول تُعد الدراسات الإنسانية ترفًا يمكن تأجيله وربما الاستغناء عنه.
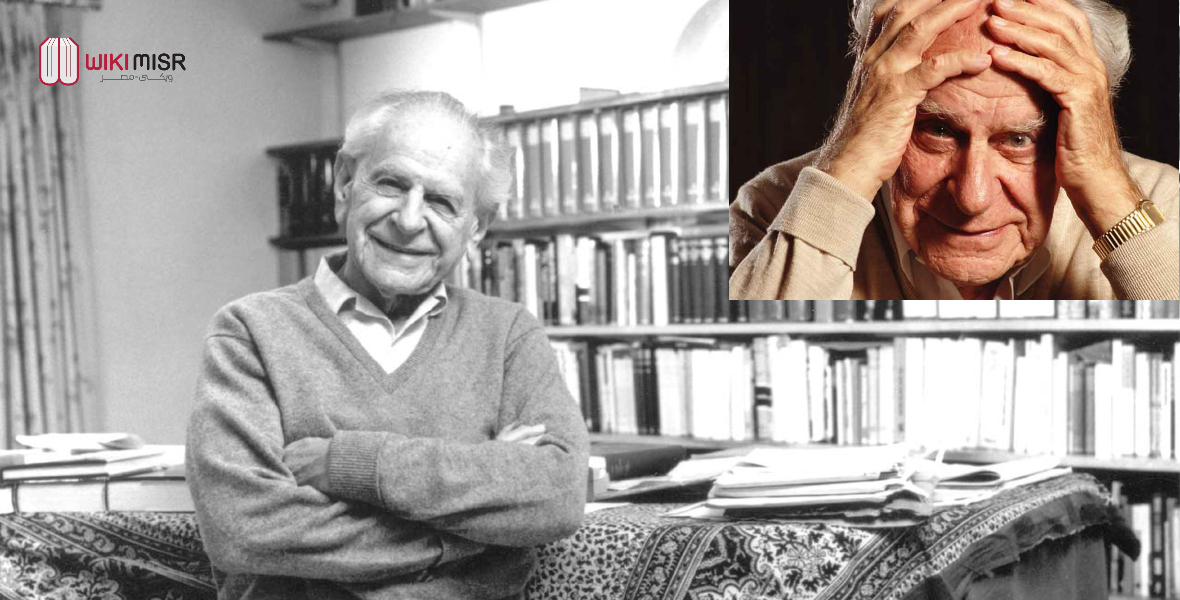
كذلك تتناول المؤلفة تأثير الإيديولوجيا على العلوم الإنسانية، وتطرح في نهاية الفصل طريقًا للحل عبر التمييز بين ما هو علمي، وبين ما هو غير علمي ويتعلق بالإيديولوجيا أو الفلسفة، وأن تصاغ الفروض العلمية بطريقة خالية من الإيديولوجيا. ويمكن الرجوع إلى المعيار الذي وضعه كارل بوبر للعلم، وهو القابلية للتكذيب criterion falsifiability؛ فالقضية العلمية هي التي يمكن إثباتها أو نفيها، أما إن كانت لا يمكن تخطئتها فهي مسألة غير علمية.
المعرفة بين الاستنباط والاستقراء
تناول الفصل الخامس عملية الاستنباط Deduction، لأن التفسير في كل من العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية يرتبط بالاستنباط. الاستنباط يتم وفق مسارين، الأول: تقريرات جزئية بخصوص الظاهرة المطروحة للدراسة، والثاني: العبارات أو القوانين الكلية التي يصلح تعميمها فيما بعد.
أوضحت المؤلفة الفرق بين “الإبستمولوجيا الكلاسيكية” التي ترتكز على منهج الاستقراء Induction، حيث يبدأ بملاحظة الظاهرة أولًا ثم يصيغ قاعدة كلية قابلة للتعميم، في مقابل “الإبستمولوجيا المعاصرة” التي ترتكز على الاستنباط، حيث يفترض الباحث فرضًا معينًا بخصوص الظاهرة التي يدرسها ثم بعد ذلك يختبر صدقها أو يُكذّبها. وفي الأخير، فمشكلات العلوم الإنسانية ترتد إلى عاملين اثنين هما: العلاقة بين الباحث والقضية محل البحث، وكذلك موضوع البحث.
وداعًا للحتمية العلمية
في الفصل السادس والسابع، تتناول المؤلفة مبدأ “الحتمية العلمية” الذي رافق العلم الحديث في الفترة بين القرنين 17 و 19، والذي لم يلبث أن تراجع مع ظهور النظرية النسبية ونظرية الكمومية Quantum، وأصبحت نظرية نيوتن مقتصرة على الكتل الضخمة لا يمكن تعميمها على أعماق المادة كالذرات التي هي المكون الأساسي للوجود.
بالتالي انقلبت نظرية المعرفة -أو الابستمولوجيا- المعاصرة انقلابًا جذريًا من الحتمية Determinism إلى اللاحتمية Indeterminism، أي من النقيض إلى النقيض، وصارت التعميمات المطلقة التي كان يطلقها العلماء حول الظواهر الإنسانية أمرًا غير مقبول، فهذه التعميمات لم تعد تصلح حتى في العلوم الطبيعية فكيف نقبلها في العلوم الإنسانية؟!
أخيرًا، تناول الكتاب إمكانية حل مشكلة العلوم الإنسانية، وأهمية ألا تقتحم الإيديولوجيا المشاريع العلمية، وكذلك ألا يرفض العلم مشروعًا حضاريًا بعينه ويقبل آخر، وحثّت الباحثين العرب على استلهام تراثنا الزاخر وواقعنا المعاصر في إيجاد فروض علمية قادرة على الإحاطة بالظواهر الإنسانية، فيظل التراث والأيديولوجيا رصيدًا هائلًا للعلوم الإنسانية عبر تحويله إلى مادة قابلة للتداول بين العلماء والباحثين.
